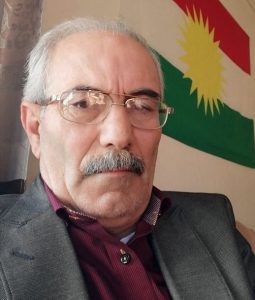
تُعدّ القومية من أكثر المفاهيم تأثيرًا في تشكيل العالم الحديث، إذ شكّلت منذ بدايات القرن العشرين حجر الزاوية في بناء الدول المستحدثة بعد انهيار الإمبراطوريات التقليدية. غير أنّ القومية، في مسار تطوّرها التاريخي، لم تكن مفهومًا واحدًا أو ثابتًا، بل خضعت لمقاييس تتماشى مع مصالح الدول المستعمِرة، حيث رُسِّخت الخرائط السياسية على أنقاض الخرائط العسكرية ومناطق النفوذ، دون أخذ الحقوق القومية للشعوب الأصيلة بعين الاعتبار، مثل الشعب الكوردي والشعب الأمازيغي. وبذلك اتخذت القومية شكلين مختلفين:
أحدهما سياسي يرتبط بالسلطة والدولة.
والثاني ثقافي–هويّاتي يقوم على الارتباط الطبيعي بالجماعة والثقافة واللغة والجغرافيا.
أولًا – القومية بالمفهوم السياسي
القومية السياسية هي نتاج مشروع الدولة الحديثة، وتستند إلى فكرة أن لكل أمة الحق في دولة تمثّلها وتعبّر عن إرادتها. لكن في التطبيق العملي، تحوّلت هذه الفكرة في العديد من بلدان الشرق الأوسط إلى أداة للسيطرة السياسية، إذ تبنّت النخب الحاكمة، والتي كانت في الغالب عسكرية، هوية قومية واحدة على حساب بقية المكونات.
في تركيا، تأسست الجمهورية على أساس القومية التركية التي جعلت من “التركية” الهوية الرسمية الوحيدة، وتم تجاهل الهويات الأخرى – كالكورد والعرب والأرمن – بل وجرى قمع لغاتهم وثقافاتهم باسم الوحدة الوطنية.
وفي العراق وسوريا، تحوّلت القومية العربية إلى أيديولوجيا سياسية تبنّتها أنظمة الحكم، مما أدّى إلى تهميش القوميات الأخرى كالكورد والآشوريين والتركمان. وهكذا أصبحت الدولة القومية مشروعًا مركزيًا للهيمنة أكثر من كونها كيانًا جامعًا للتنوع.
أما في إيران، فقد اندمجت القومية الفارسية مع الهوية الدينية الشيعية لتشكّل الهوية الرسمية للدولة، في مقابل تهميش القوميات الأخرى كالبلوش والكورد والعرب والأذريين.
في هذه النماذج، تمثّل القومية السياسية هوية الدولة الرسمية التي تُفرض من الأعلى، لا هوية الشعوب التي تعيش داخلها. وبذلك تباعدت الدولة عن المجتمع، وتحولت القومية إلى أداة للهيمنة أكثر من كونها تعبيرًا عن الانتماء.
ثانيًا – القومية كمفهوم هوية
في المقابل، تمثّل القومية في بعدها الهويّاتي رابطًا ثقافيًا وإنسانيًا، يُعبّر عن شعور الانتماء المشترك بين أفراد جماعة ما، انتماءٌ يتأسس على اللغة والتاريخ والجغرافيا والذاكرة الجمعية، لا على السلطة السياسية.
★ القومية الكوردية مثال واضح على هذا البعد الهويّاتي، إذ تمتدّ عبر أربع دول (تركيا، العراق، سوريا، إيران) دون كيان سياسي موحّد.
وبالرغم من أن نضال الكورد عبر قرن من الزمن كان يهدف إلى تحقيق الاعتراف بهويتهم الثقافية والسياسية والاجتماعية دون المساس بالخرائط السياسية، فإن ردّ القوميات السياسية التي تهيمن على الدول التي تحتل كوردستان كان القمع والتهميش والتغيير الديموغرافي والصهر القومي.
وبرغم كل تلك المحاولات التعسفية من قبل القوميات السياسية، حافظ الكورد على هويتهم القومية بفضل اللغة والثقافة والوعي التاريخي المشترك.
★ الأمازيغ في شمال إفريقيا (المغرب، الجزائر، ليبيا، تونس) يمثّلون أيضًا قومية هوية تسعى إلى الحفاظ على لغتها وثقافتها الأصلية ضمن إطار وطني تعددي.
وبعد عقود من التهميش تحت تأثير الفكر القومي العربي، بدأت المنطقة تشهد اعترافًا تدريجيًا بالثقافة الأمازيغية كلغة وهوية أصيلة متجذّرة في تاريخ شمال إفريقيا.
بهذا المعنى، فالقومية ليست مشروعًا سياسيًا بل وعيًا بالذات الجماعية، وهي لا تهدف إلى فرض هوية على الآخرين، بل إلى الاعتراف بالذات واحترام التنوع.
«الخلاصة»
إن تجارب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُظهر أن القومية السياسية، حين تُختزل في هوية واحدة تفرضها السلطة، تتحوّل إلى عامل انقسام وصراع، بينما يمكن للقومية في بعدها الهويّاتي أن تكون أساسًا للتنوع الثقافي والتعايش المشترك.
إن ضمان حقوق الشعوب في الدولة الواحدة يقوم على مبدأ المواطنة المتساوية واحترام الهوية القومية والثقافية لكل مكوّن، مع تمكينه من المشاركة الفاعلة في الحكم وصون لغته وتراثه.
وتُعدّ الأنظمة الديمقراطية التعددية، والاعتراف الدستوري بالتنوّع القومي، من أهم الوسائل لحماية هذا التعدّد وتحويله إلى عامل وحدة واستقرار بدلًا من الانقسام والنزاع.
 جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر


