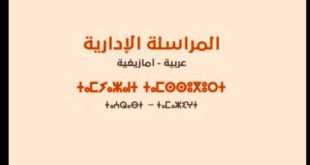تفاجأت، كالكثيرين، بكمّ التفاعل الهائل الذي رافق ما سُمّي بـ”مناظرة” بين الأستاذين أحمد عصيد وطلال الحلو على قناة ميدي 1. فمن جهة، انهالت الانتقادات على عصيد، المعروف بمواقفه الجريئة والمتماسكة، ومن جهة أخرى، سُجّل تنويه غير مسبوق بالأستاذ الحلو، حتى بدا وكأننا أمام نجم جديد صاعد لا مجرد مشارك في نقاش.
لكن عند مشاهدتي لهذا “النقاش”، خرجت بانطباع مختلف تمامًا، أولها أن ما شاهدته لا يرقى إلى مرتبة مناظرة، لا في الشكل ولا في المضمون. فالمناظرة، كفن حجاجي، لها شروط دقيقة: تكافؤ في الوقت، وضوح في المحاور، التزام بقواعد النقاش، وكل هذا غاب لصالح ما بدا وكأنه مجرّد مواجهة لفظية غير متوازنة.
لاحظت أن الأستاذ طلال الحلو، رغم هدوئه وقدرته على التحدث بالفرنسية بطلاقة، كان يعتمد على أوراق معدة سلفًا، يقتطف منها مقاطع وأقوالًا قديمة لعصيد، ليواجهه بأسئلة جاهزة، كأنه جاء بـ”ملف إدّعاء” أكثر من كونه محاورًا حاضر الذهن. أما على مستوى التحليل، فقد بدا سطحياً في تفكيكه، رغم تخصصه المعلن في الاقتصاد والفكر الإسلامي.
في المقابل، حافظ الأستاذ عصيد على انسجامه وتماسكه، حتى وإن لم تُمنح له المساحة الكافية لعرض أفكاره كما يجب.
ما أثار استغرابي أكثر، هو موجة الإعجاب المفاجئة بطلال الحلو، والتي دفعتني للتساؤل: هل فعلاً فاز الرجل بالحجة؟ أم أن هناك ما هو أبعد من مضمون النقاش؟
وهنا بدأتُ ألاحظ أن جزءًا كبيرًا من هذا الإعجاب لا علاقة له بالمناظرة نفسها، بل بشخص الحلو: اسمه “طلال”، وكنيته “الحلو”، وهي أسماء لا نجدها عادة في صفوف التيار المحافظ أو الحركات الإسلامية. بل ترتبط، في الوعي العام، بـ”الحداثة”، بـ”الطبقة الاجتماعية الراقية”، بالنخبة الناطقة بالفرنسية، بالصورة الأنيقة.
بكلمات أخرى، بدا لي أن ما شهدناه لم يكن انبهارًا بأفكار طلال الحلو، بل بالرمزية الثقافية والاجتماعية لاسمه وصورته ونبرته، وكأن “الحداثة” استعارت وجهًا جديدًا، غير الوجه التقليدي للتيارات السلفية.
وهذا ما يدعونا لطرح سؤال أعمق: إلى أي حد أصبحنا، كمجتمع، ننجذب إلى الصورة أكثر من الفكرة؟ وإلى أي مدى يمكن للاسم واللغة والمظهر أن تعوض عن عمق التحليل في تشكيل الرأي العام؟
 جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر