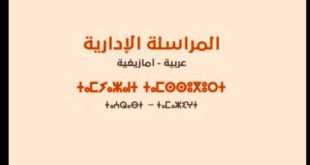بقلم الدكتور ابراهيم الگبلي أستاذ الأدب المقارن
الولايات المتحدة الأمريكية
انتشر في الآونة الأخير خطاب “مُتَبَرْبِر انغماسي” يشتغل بشكل كبير على شكل لايفات و “بوكسطات” وفيديوهات في الفايسبوك وموقع يوتوب وغيرها. نظريا، هذه الخطابات مهمة، بل أساسية، لتحقيق دمقرطة المشاركة في صناعة الرأي العام ونشر المعرفة في عالم لم يعد فيه للحدود معنى ولم تعد فيه نفس القوة لوسائل التكوين الكلاسيكية. غير أن الإقرار بأهمية وسائل التواصل وضرورة الاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها لا يجب أن ينسينا محاذيرها الخطرة فيما يتعلق بطبيعة وطريقة اكتساب العلم والمعرفة مما يفرض التمييز بين “المعرفة اليوتوبية” و المعرفة التي يستفيدها القارئ، وخاصة الطالب والطالبة، من بواطن الكتب والمجلات العلمية.
قبل تقديم بعض الأفكار للتمييز بين معرفة اليوتوب ومعرفة الكتب، أود الإقرار بأن هناك قنوات يوتوب ولايفات فايسبوكية محترمة جدا لايختلف المحتوى الذي تقدمه عن محتوى المحاضرات الجامعية الرصينة. فمن يقدمون هذه المواد يعملون على شكل فريق ويقومون ببحث جدي لجمع المعطيات وتحليلها، وغالبا ما يكون بينهم من يقوم بالتحقق من الحقائق (fact checkers)قبل تقديمها للمشاهدين. كما أن هناك فرقا شاسعا في الجودة بين البرامج المسجلة واللايفات المباشرة التي تتحول، في الغالب، إلى مجال لنشر آراء تفتقد للدقة والصرامة اللازمتين لتطوير وعي المشاركين المهتمين بالنقاش المطروح.
أعود الآن إلى الفرق الأساسي بين معرفة الكتب ومعرفة اليوتوب لأقول إن شبيه بالفرق بين الوجبات السريعة والطبخ المنزلي التقليدي. فالوجبة السريعة لذيذة في الغالب ولكن آكلها لا يعرف لا منشأ ولا طبيعة المواد المستعملة في طبخها لأنه يريد فقط إشباع جوعه والذهاب في حال سبيله. أُكلة البيت، في المقابل، هي نتاج مسلسل معروف ويبدأ من الخروج من البيت والذهاب عند الخضار والتوقف عند الجزار وشراء البهارات وغيرها من مستلزمات الطبخ. فعندما تُعِدُّ أكلةً في البيت، فأنت لا تعرف فقط ماذا أكلت ولكنك تتحكم أيضا في مسار صناعة الأكلة من أولها إلى آخرها. بالمعنى الأكاديمي، فأنت تمتلك منهجية وأسلوب عمل يمكنك من التفكير في كل مراحل العملية التي مررت بها من أجل إنتاج المنتوج النهائي الذي ستأكله. أما الذي يستهلك أُكلة سريعة، فيعرف فقط مذاق الأكلة وكيفية تفاعل لسانه معها ولن يستطيع بضرورة إعادة تركيب مسار إعدادها لأن لم يشارك فيه. في المقابل، يستطيع الذي يطبخ أكلته أن يقوم بتجويد الأكلة كل مرة بتغيير المقادير والإبداع في طريقة الإعداد. الفرق هنا، إذن، بين من يتحكم في آليات العمل وبين المستهلك فقط.
هذا ينطبق بين مستهلك معرفة لايفات يوتوب وفايس بوك وبين من يكتسب معرفة مضنية عن طريق قراءة الكتب والتنقيب في المصادر. فالأول قد يتعلم الكثير عن النقاشات الجارية والاشتباكات القائمة حول مواضيع الساعة ولكنه غالبا ما يكون عاجزا عن فهم أصول ومخرجات الأفكار التي يتشربها في حين أن الثاني يكتسب كفايات تساعده في حياته للأبد لأنه يطور عدة من المهارات تمكنه من التعامل مع الواقع بأسلوب نقدي غير استهلاكي. عندما نطبق هذا النموذج على الامازيغية، سنجد أن سوق معرفة اليوتوب واللايفات كبير وفي اتساع مستمر. فعدد الناس الذين يعتقدون أنهم لا يتوفرون على الوقت الكافي للاطلاع على تاريخ الحركة الأمازيغية من مصادره المكتوبة، مثلا، كبير ويضاف إليهم عدد لا حصر له لا يعرف حتى بوجود مصادر مهمة كثيرة عن الأمازيغية مما يوفر كتلة كبيرة من الزبناء لسوق المعرفة اليوتوبية والفايسبوكية. كل هذا يتعقد أكثر بسبب غياب ثقافة نقد وبحث متجذرة مما يزيد من خطر انتشار الأفكار والتصورات غير المبنية على أساس علمي. علاوة على كل هذا، لابد من الإشارة إلى أن المزج بين الصوت والصورة يعزز من قوة الإقناع التي يتميز بها من يعملون اللايفات.
هذا بطبيعة الحال ليس خطأ أصحاب قنوات اليوتوب والفايسبوك. فهم يوفرون منتوجا وهذا المنتوج سيستمر طالما له زبناء يبحثون عن المعلومة السريعة التي لا يحتاجون لمعرفة مصدرها وعن الآراء التي لا يمكن إعادة صياغة أصولها بشكل علمي محض. فعلي سبيل المثال، انتشرت أفكار عن السنة المورية والفكرة المورية من خلال المعرفة اليوتوبية واللايفات الفايسبوكية مؤخرا. رغم أن تسويق هذه الأفكار يتم بطريقة إدماجية (inclusive) إلا أن هذه الأفكار تحمل في طياتها خطرا على الكيان الوطني لما تنذر به من شوفينية وإثنوقومية ستكون نتائجها كارثية كما حدث مع الآرية في ألمانيا. هذا فقط نموذج لاستعمال المعرفة التاريخية اليوتوبية بشكل استهلاكي يتسم بالكثير من الخطر على الأجيال المستهلكة لهذا الخطاب الجوهراني (essentialist) مما يستدعي الحذر من عواقب التجييش والتغليط اللذان ينبعان من سطوة المعرفة اليوتوبية.
أما معرفة الكتب فاكتسابها يتطلب وقتا وجهدا أكبر. فالبحث في المصادر واكتشاف تقاطعاتها ومراقبة نشأة وتطور فكرة معينة من مصدر إلى آخر ومن اجتهاد الى اجتهاد عمل مختلف عن الاستهلاك اليوتوبي اللذيذ والسطحي في أغلب الأوقات. الأهم، بالنسبة لي، هو أن مسلسل اكتساب هذه المعرفة يساعد على تملك ملكات النقد والتشكيك والمقارنة التي تمكن صاحبتها من الخروج بآراء مبنية على تمحيص مصادر المعرفة دون “فلترة” (filtering) من أي شخص آخر غير القارئ المَعني نفسه. فعندما نقرأ تاريخ الحركة الأمازيغية ونفحص أمهات الكتب التي أنتجها عمالقة هذه الحركة (من أمثال محمد شفيق، إبراهيم أخياط، أعراب بيسعود، محمد تلماتين، سعيد سيفاو، إلخ) في ظروف تاريخية صعبة جدا نجد أن الحركة الأمازيغية، سواء في تامازغا أو في الشتات الأمازيغي العابر للقارات، لم تكن أبدا حركة متجانسة بل كانت تتجاذبها تيارات تختلف على كل شيء إلا على كون الأمازيغية مهمشة ولم تحظ بنصيبها من الاعتراف في أوطانها. اليوتوب لن يقدم هذا التاريخ كما يجب في وجباته السريعة لأنها تتطلب مسارا مختلفا من البحث والنقد والتمحيص يساعد من يقوم به، في المحصلة، على تشكيل رأي مبني على العلم وليس على الارتسامات أو على آراء ثانوية من خلال قراءات أشخاص آخرين للمصادر الأصلية. فالرجوع إلى الأصل عملية مهمة لتأسيس معرفة قوية وقادرة على الصمود أمام الآراء التي تحاول تشويه مسار الحركة الأمازيغية وتاريخها. في المحصلة، المعرفة اليوتوبية هي نوع من “ماكدونالدز” الأفكار—قد تكون الوجبة جيدة ولذيذة ولكن آثارها الصحية على المدى البعيد مدمرة.
ختاما، يجب على الطلبة والطالبات، بالخصوص، أن يهتموا بتشكيل وعيهم وامتلاك أدوات البحث عن طريق معرفة الكتب وليس عن طريق معارف اليوتوب واللايفات الفايسبوكية. لليوتوب أهمية كبيرة في نشر الأمازيغية والتوعية بوجودها كقضية دولتية ولكن يجب الحذر من استعمالاته كمصدر لاكتساب المعرفة التاريخية والنقدية لأن هذه المعارف لا تُكتسب إلا بطرق معقدة تتطلب وقتا كافيا للإحاطة ليس بالمعارف فقط ولكن بالآليات المنهجية والطرق النقدية لإنتاج المعرفة.
 جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر