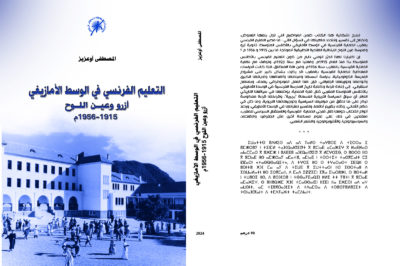
1.في البداية تتقدم لكم جريدة العالم الأمازيغي بأسمى عبارات التهاني والتقدير بمناسبة نيلكم جائزة الثقافة الامازيغية، وبهذه المناسبة قدم لنا نبذة حول عملكم الذي نال الجائزة، وماذا تعني لكم جائزة الثقافة الأمازيغية وماهي قيمتها المضافة بالنسبة لمسيرتكم؟
في البداية أتقدم لك ولكم جميعا في جريدة العالم الأمازيغي، الجريدة المناضلة والمستقلة عن الدولة والأحزاب السياسية، والتي تضع الدفاع عن الأمازيغية وبكل تجلياتها في صلب خطها التحريري، وسلاحها في كل ذلك الإيمان بعدالة قضية الشعب الأمازيغي.
العمل الذي نال جائزة الثقافة الأمازيغية لسنة 2024هو كتاب بعنوان “التعليم الفرنسي في الوسط الأمازيغي: أزرو وعين اللوح 1915-1956م”.
جدير بالذكر أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يخلد كل يوم 17 أكتوبر من كل سنة ذكرى الخطاب الملكي السامي بأجدير وإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
ولقد خلدت المؤسسة بمقرها إبان الفترة ما بين 13 و17 أكتوبر 2025 مجموعة من الأنشطة الثقافية والعلمية والفنية المعهد تحت شعار: الأمازيغية وإنتاج المعرفة، ومن أهمها تسليم الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024، يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 على الساعة العاشرة صباحا، شملت مختلف الأصناف، ومنها صنف الدراسات والأبحاث.
أصل الكتاب جزء من أطروحة جامعية قدمت لجامعة ابن طفيل شعبة التاريخ بالقنيطرة للحصول على درجة الدكتوراة في يوليوز 2021م. وهو كتاب حاول الإجابة عن سؤال مصير المدرسة الفرنسية في الوسط الأمازيغي بالأطلس المتوسط من خلال دراسة حالتي ثانوية أزرو- البربرية ومدرسة عين اللوح- البربرية الابتدائية خلال فترة الحماية الفرنسية بالمغربية 1915-1956م، إذ؛ فشلت في تحقيق غاياتها أهدافها السياسية البعيدة القائمة على عزل الأمازيغ عن العرب، وتطويرهم في اتجاه الثقافة واللغة الفرنسيتين، فجاءت المدرسة الفرنسية في الوسط الأمازيغي بعكس ما كانت تنوي سلطات الحماية على خط مستقيم.
لم يكتف الكتاب بوصف الوقائع والأحداث بل حاول تفسير فشل المدرسة الفرنسية في الوسط الأمازيغي، بمجموعة من العوامل المتداخلة، منها ما يرتبط بفلسفة التربية، أي التوجيهات السياسية والتربوية التي لم تكن مؤسسة على أسس علمية صلبة ودقيقة، إذ؛ استندت على نتائج تقارير متسرعة، فتمت صياغة السياسة التربوية المسماة “بربرية” بشكل مرتجل، وعلى أسس “طوباوية” لا تعكس حقيقة التركيبة الإثنية والاجتماعية والنفسية للوسط الأمازيغي، وتنم عن جهل أو تجاهل للتوزيع الجغرافي للسكان في جبال الأطلس المتوسط، وتقييم خاطئ للذهنية الأمازيغية وللتطور الواقعي للبلاد، وللقوى الفعلية العميقة العاملة فيها، والوصول إلى استدلالات خاطئة، مبنية أحيانا على ملاحظات ووقائع قريبة إلى الصحة.
ومنها ما يرتبط بالمنفذين لتلك السياسة، على أرض الواقع، من ضباط للمراقبة المدنية والعسكرية وأساتذة ومعلمين ومديرين، الذين اختبروها غير قابلة للتطبيق، فرفضوها واعتبروها مهددة للوجود الفرنسي في الوسط الأمازيغي خاصة، والمغرب عامة.
ومنها ما يرتبط بالمجتمع في الوسط الأمازيغي، في توجهه العام، الذي لم يتفاعل إيجابيا مع المدرسة الفرنسية العصرية، وأمسى يتشبث بالمدرسة القرآنية، والزاوية، والطريقة الصوفية.
ومن عوامل فشل المدرسة الفرنسية في الوسط الأمازيغي كذلك، العوامل الخارجية المرتبطة بتقلبات العلاقات الدولية وما ترتب عنها من أزمات سياسية واقتصادية، وتقلبات سياسية عرفتها فرنسا ما بين الحربين، أثرت بشكل سلبي على مستعمراتها، ومن ضمنها المغرب، الذي ظهرت به الحركة الوطنية خلال ثلاثينيات القرن العشرين، والتي شنت حملة سياسية وإعلامية في الداخل وفي الخارج ضد إصدار ظهير 16 ماي 1930م، وطالبت بإصلاحات جزئية، سرعان ما تحولت إلى مطالب جذرية خلال الأربعينيات دعمتها البورجوازية الحضرية الفاسية بشكل خاص، والتي تضررت أعمالها بسبب المنافسة القوية لرجال الأعمال الأوروبيين، ولم تقتصر على المجال الحضري بل امتدت إلى المجال القروي والجبل بالوسط الأمازيغي، الذي تقدمت فيه الدعاية الوطنية بشكل كبير عبر دعاتها الذين ابتكروا أدوات تواصل جديدة للانفلات من الرقابة الشديدة المضروبة على الجبل من طرف السلطات العسكرية، فاستثمروا الجوامع والزوايا وحلاقي الأسواق الأسبوعية ووظفوا اللغة الأمازيغية في الدعاية ضد الوجود الفرنسي بالأطلس المتوسط، هذا في وقت أصبحت فيه السلطات الاستعمارية عاجزة على السير في تطبيق سياستها البربرية في مجال الإدارة والقضاء والتعليم.
وعموما، فلقد أدى تضافر مجموع العوامل الداخلية الذاتية المرتبطة بمدخلات، ومنهاج المدرسية البربرية، والموضوعية المرتبطة بمخرجاتها المرتبطة بالمتعلمين ووسطهم السوسيو-ثقافي، والعوامل الخارجية المرتبطة بتقلبات العلاقات الدولية وما ترتب عنها من أزمات سياسية واقتصادية، إلى تعثر وفشل المدرسة الفرنسية في الوسط البربري.
لقد أدى إدخال المدرسة الفرنسية في الوسط الأمازيغي بالأطلس المتوسط المغربي إلى جملة من النتائج الثقافية، والاجتماعية، والسياسية.
على المستوى الثقافي: إذا كان دور المدرسة الأصلي هو مساعدة المتعلمين في نموهم العقلي والوجداني السوي والمتوازن والمنسجم، فإن المدرسة الفرنسية في الوسط الأمازيغي تطورت في سياقات اجتماعية وسياسية وثقافية مضطربة وصعبة جدا. أدت إلى تهميش الثقافة واللغة الأمازيغيتين، وحصر اللغة العربية في مجال ضيق، في مقابل توسيع مجال تداول اللغة والثقافة الفرنسيتين، إذ خصصت لمواد اللغة الفرنسية وللدرس اللغوي الفرنسي، حصة الأسد في برامج التعليمين الابتدائي والثانوي في الوسط الأمازيغي، ولقد أدت تلك الوضعية، إلى اختلال ثقافي بسب التجاذبات الثقافية لمؤسسات متنوعة غير منسجمة ومتناقضة مثلتها الأسرة والمسيد والمجتمع والمدرسة الفرنسية، أدت إلى اضطراب فكري لدى التلاميذ الأمازيغ، تجلت معالمه في عقدة النقص تجاه الثقافتين والحضارتين الفرنسية والعربية، واحتقار الوسط الثقافي –الأمازيغي المنغلق، والمعزول، والمتميز بسيادة العادات المتجاوَزة، وبالتخلف التقني.
كانت تلك العقدة تجعل الأمازيغي المتعلم، فريسة للتضاد النفسي الذي ظل يمزقه بشكل قهري وهو مجرد من أدوات المقاومة الذاتية التي لم تسمح بها المدرسة الفرنسية باكتسابها، من قدرات على الملاحظة والتفكير والاستقلال والنقد الذاتي والموضوعي ومراجعة الخرائط الذهنية المكتسبة، والمسلمات، والمكتسبات المتجذرة، والتمثلات والأفكار المسبقة، والآراء الغالبة، وحمولات مختلف البيداغوجيات الأخلاقية الدوغمائية التي يتلقاها في وسطه الأمازيغي وفي المسيد والمجتمع والمدرسة الفرنسية العصرية، والمشكلة لمخياله التي تجعله في حالة اضطراب دائمة تعيقه على التمييز بين الأسطورة والحقيقة التاريخية، بسبب تجاور مفاهيم ذهنية متناقضة في التفكير وغياب الرابط المنطقي بين ما يتلقاها التلميذ من معارف جديدة في المدرسة ووسطه الاجتماعي، فمثلا ما يُعتبر ظاهرة طبيعة في دروس الأشياء كالزلازل والبراكين والجفاف مفسرة تفسيرا علميا. يعتبر في وسطه علامات ومظاهر لقوى خارقة، مفسرة تفسيرا خرافيا، دون أن تلغي معارف المدرسة معارف الأسرة والمسيد والمجتمع، وكل ذلك بمسوغ أن المدرسة الفرنسية ملزمة بالتزام الحياد وأن دورها يجب أن ينحصر في تعليم التقنيات واكتساب المعارف العملية، وإن كانت نظرية أحيانا إلا أنها مفصولة عن الوسط الاجتماعي للمتعلمين ومكرسة هي الأخرى للقصص والأساطير المتوسطية القديمة وللفلكلور المشرقي في مكون القراءة باللغة الفرنسية، بلغتين في غاية الصعوبة والتعقيد: الفرنسية والعربية الفصحى. ويتجلى كذلك التناقض الممزق، مثلا، في الجمع في الحياة اليومية للمتعلمين بين سلوكات علمية تارة، وخرافية تارة أخرى، وبين ارتباطه بالأرض وبالجبل وبالأجداد، وبتاريخهم، خاصة المقاومة المسلحة، ورفضه لبعض العادات والتقاليد، إذ كان الجبل بالنسبة للتلاميذ الأمازيغي رمزا للحرية، فيما كانت المدينة انضباطا لمجموعة من القواعد.
وأمام عقدة النقص التي عانى منها التلاميذ الأمازيغ خاصة، بثانوية أزرو، فإنهم كانوا ينشدون تغيير الأوضاع العامة بواسطة التعليم عامة، وتعليم المرأة الامازيغية بشكل خاص، وستتغير هذه الوضعية بعد حصول المغرب على استقلاله السياسي، ففي الوقت الذي استمرت فيه عقدة النقص لدى الآباء وغير المتعلمين من الأمازيغ بالجبل من اللغة والهوية الأمازيغية أمام الأجانب، وخاصة عند فترات العبور أو الاستقرار المؤقت بالمدن والحواضر الكبرى، ستتخلص نخبة من المتخرجين من ثانوية أزرو ومن الجامعات المغربية من تلك العقدة تجاه الانتماء إلى اللغة والثقافة الأمازيغيتين.
وعلى المستوى الاجتماعي: أدت المدرسة الفرنسية في الوسط الأمازيغي إلى انقسام المجتمع إلى فريقين: فريق رفضها، واعتبرها ” رومية “، وقاطعها، وتمسك بالإرث الثقافي، ما قبل الحماية، وبالمدرسة القرآنية، واتجه إلى تأسيس مدارس حرة، وفريق ثان، دعا إلى الانخراط فيها، لأنه قدر حتمي بسبب تفوق ميزان قوى الاستعمار، واعتبارها أداة لاكتساب أسلحة العدو.
ويبدو أن انقسام المجتمع في الوسط الأمازيغي إلى فريقين، وبالتالي إلى موقفين من المدرسة الفرنسية العصرية، أدى إلى إنتاج رأيين مختلفين للمجتمع، رأي تقليدي يهدف إلى تكريس مغرب ما قبل الحماية، بواسطة المدرسة القرآنية، والزاوية، والطريقة الصوفية، وجامعة القرويين، ورأي عصري منفتح على مؤسسات الحماية الفرنسية، وعلى الميتروبول، بدافع الوعي بالتأخر الذي يعرفه المجتمع المغربي عامة، والأمازيغي خاصة، ومحاولة تجاوز الوضع عن طريق التعليم العصري، بانتاج نخب عصرية قادرة على بناء مجتمع بديل.
ويبدو أن الرأي الأول يمثل الأغلبية في الوسط الأمازيغي، فيما يمثل الثاني الأقلية، ولقد عملت الأغلبية المحافظة، على عرقلة الأقلية المنفتحة، وحالت دون انتشار أفكارها على نطاق واسع. وبالتالي فالتحول الذي عرفه المجتمع في الوسط الأمازيغي، كان تحولا بطيئا ومحدودا جدا، إذ؛ لم تحدث المدرسة الفرنسية في الوسط الامازيغي، القطيعة مع مغرب ما قبل الحماية فأصبح المجتمع مركبا من اتجاهين: واحد تقليدي، والآخر عصري، يتعايشان تارة، يصطدمان تارة أخرى، ولقد استمرت الوضعية، خلال مرحلة الاستقلال السياسي، إلى مرحلتنا الراهنة.
أدت المدرسة الفرنسية في الوسط الأمازيغي، التي راهنت على إعادة ابن الفلاح إلى أرضه، وعلى تجنيد الجندي في الجيش الفرنسي والعامل في المصانع والورشات الأوروبية، إلى حرمان التلاميذ من التعليم الديني واللغة العربية، والتعليم العالي، وحرمان نصف المجتمع الفتاة والمرأة القرويتين من التعليم، وحرمان الجبل الأمازيغي من أبنائه بسب حملات التجنيد الفرنسية المهينة، إذ كان التلاميذ المغادرون للمدرسة مضطرون لبيع أجسادهم، لحما للمدافع، مما كان يؤدي إلى إفراغ الجبل من القوى العاملة، مما يتسبب في تراجع الأنشطة الإنتاجية، واللجوء إلى الأجراء، من خماسة ورعاة، كما حرمت المدرسة الفرنسية، خاصة ثانوية أزرو، الجبل من نخبته، على قلتها إلا أنها كانت أقلية استراتيجية، والتي عوض أن تخدم وسطه، حُمّلت مسؤوليات حساسة في ميادين القضاء والجيش ووزارة الداخلية ووزارة التعليم خلال فترة الاستقلال السياسي للمغرب، مساهمة في الانتقال السلمي للسلطة بالمغرب من الاستعمار إلى الاستقلال، وفي الدفاع عن النظام الملكي وعن الوحدة السياسية والاجتماعية بمغرب الاستقلال، وإن هدد بقوة جزء من النخبة العسكرية النظام الملكي في فترة من الفترات.
[قدر حسن الزموري الذي كان كاتبا عاما للوزارة (الداخلية) آنذاك، أن عدد القواد منهم كان يبلغ 250 في سنة 1960، من مجموع 320 قائد [أي 78.12٪]، كما بلغ عدد الوزراء منهم أيضا خمسة في سنة 1966، وهم محمد العادلي والمحجوبي أحرضان وعبد الحميد الزموري والجنرال أوفقير وحدو الشيگر”. يراجع، واتر بوري، جون، أمير المؤمنين الملكية والنخبة السياسية المغربية، [ترجمة: عبد الغني أبو العزم – عبد الأحد السبتي – عبد اللطيف الفلق]، م، س ص.166].لقد استفادت المدينة المغربية من النخبة الأمازيغية، أكثر مما استفادت منها بوادي وقبائل الأطلس المتوسط، التي تعرضت للإفراغ الجماعي لسكانها، بسبب حملات التجنيد الفرنسية، ونزع أراضي القبائل، الخاصة والجماعية، من طرف المعمرين وبعض المتعاونين معهم، مما دفع بهم إلى الهجرة الفردية أو الجماعية، نحو المدن الداخلية أو الساحلية أو المنجمية أو إلى فرنسا، وهو الأمر الذي أدى في النهاية إلى تدعيم مكانة المدن والحواضر المغربية على حساب البادية في الوسط الأمازيغي.
وأخيرا وعلى المستوى السياسي أدى بناء السياسة المسماة “بربرية” عامة، والسياسة التربوية – البربرية خاصة، على خلاصات أبحاث تاريخية واجتماعية ولسانية، متسرعة وغير رصينة، إلى ارتكاب أخطاء سياسية فادحة، أدت إلى نتائج عكسية، وساعدت على ظهور الحركة الوطنية، مباشرة بعد إخراج ظهير16ماي لسنة 1930، وأدت إلى جمع المغاربة عربا وأمازيغ، بدل تفريقهم، لمواجهة الاستعمار الفرنسي في إطار كتلة العمل الوطني، التي وضعت برنامجا أطلق عليه اسم “مطالب الشعب المغربي “، سلم لكل من السلطان والسلطات الفرنسية في فاتح دجنبر 1934، تضمن ثلاثة عشرة بندا، دعا في البندين الرابع والخامس، “إلى توحيد برنامج التعليم في سائر المدارس التي تؤسس لتعليم الاهالي، سواء في المدن أو القبائل، وتعميم اللغة العربية التي هي لغة القرآن فيها وتعميم تعليم الدين الاسلامي، وجعلها لغة البلاد الدينية والرسمية في الادارات كلها بالإيالة الشريفة، وكذلك في سائر المحاكم، وعدم اعطاء أي لهجة من اللهجات “البربرية” أي صفة رسمية ومن ذلك عدم كتابتها بالحروف اللاتينية”، وهي مطالب جزئية ستعرف تحولات جدرية خلال الأربعينات من القرن الماضي، من مجرد المطالبة بالإصلاحات إلى المطالبة بالاستقلال التام، ولقد ساهم أبناء الوسط الأمازيغي في الحركة الوطنية، إذ وقعوا على وثيقة المطالبة بالاستقلال يناير 1944، وشاركوا في التعبئة لها، كما تفاعل تلاميذ ثانوية أزرو معها، ونظموا إضرابا جريئا يوم 5 فبراير 1944، قدموا على إثره للمحاكمة العسكرية، التي أدانت المعلمين الأمازيغ وتلاميذ الأقسام العليا بالسجن، واعتبر ذلك حدثا مؤسسا وموجها للأجيال بثانوية أزرو، نحو الحركة الوطنية، كما وضعت الزيارة السرية للسلطان محمد بن يوسف والمفاجئة لثانوية أزرو يوم 24 دجنبر 1942، لتفقد التعليم بها، خاصة اللغة العربية والتعليم الديني، حَدّا للعزلة الجغرافية والسياسية التي عاشتها الثانوية، كما قلبت السياسة البربرية رأسا على عقب، إذ وجهتها نحو الحركة الوطنية، ولم يعد التعليم الفرنسي في الوسط البربري سريا، وفي طي الكتمان، بل أصبح مكشوفا.
وإذا كان ظهير 16 ماي 1930، قد أضر كثيرا بالسياسة البربرية عامة، والسياسة التربوية خاصة، فإن الزيارة السلطانية للثانوية، وإضراب 5 فبراير 1944، قد عصفا بالسياستين، مما أدى إلى فشل أهداف ومرامي سلطات الحماية الفرنسية، في المغرب عامة، وفي الوسط الأمازيغي بشكل خاص.
إن الغرض الأساسي من هذا الكتاب هو تقديم حصيلة السياسية الفرنسية التربوية في الوسط الأمازيغي خلال فترة الحماية الفرنسية بالمغرب ما بين 1915 و1956م، بقراءة تاريخ المدرسة الفرنسية في الجبل قراءة معكوسة تركز على ما تحقق من مراميها السياسية وتوجيهاتها التربوية، وما ظل في حكم الأمنية وذلك بتقييم أدائها، وتفسير تعثراتها في الوسط الأمازيغي، ورصد أنواع الخطاب حولها خلال فترتي الحماية الفرنسية والاستقلال السياسي للمغرب منفتحين قدر المستطاع على العلوم المساعدة الأخرى مثل الجغرافيا والاقتصاد، والسوسيولوجيا، والانتروبولوجيا، والشعر الشعبي والرواية الشفوية والمقابلات مع الفاعلين التربويين المحليين والزيارات الميدانية للمدارس والإعداديات والثانويات التي كانت تحضن تجربة محاولات تنفيذ السياسية-البربرية في مجال التعليم.
******
تتويج كتاب “”التعليم الفرنسي في الوسط الأمازيغي: أزرو وعين اللوح 1915-1956م”، يعني بالنسبة لي الشيء الكثير، فهو تتويج لمسار طويل من النضال والإيمان بعدالة المسألة الأمازيغية في تاريخ المغرب، منذ الانتماء إلى ديناميات الحركة الثقافية بالمغرب، والتي بدأت بشكل مبكر مع تأسيس أول جمعية مغربية تعنى بالنهوض وحماية الأمازيغية لغة وثقافة وهوية، مع تأسيس جمعية البحث والتبادل الثقافي سنة 1967م، وتأسيس الجمعية الجديدة للثقافة الشعبية سنة 1978م، جمعية تامينوت لاحقا، والتي كان لي ولازال شرف الانتماء إليها منذ 1994م إلى الآن، مرورا بدينامية البيان الأمازيغي مارس 2000، الذي ساهم بشكل قوي في إطلاق مسلسل الاعتراف بالأمازيغية وإعلان تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بمناسبة خطاب أجدير ليوم 17 اكتوبر2021م، والاعتراف الرسمي بالأمازيغية في الفصل الخامس من دستور المملكة المغربي سنة 2011 “…بجعلها أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.
****
الحصول على جائزة الثقافة الأمازيغية صنف الدراسات والأبحاث لسنة 2024، والتي يمنحها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كل سنة بمناسبة تخليد الحطاب الملكي لأجدير وتأسيس المعهد، هو بالنسبة لي ليس تشريفا بل تكليفا بمسؤولية وأداء واجب تجاه المجتمع المغربي عامة والثقافة واللغة الأمازيغيتين بشكل خاص ، لأن مهمة المثقف ليست في الحصول على الألقاب، بل في المساهمة الفكرية والأدبية التي تنير المجتمع وترتقي به. والجائزة في الوقت نفسه يجب أن تكون وسيلة لأداء واجب أكبر وليست غاية في حد ذاتها.
إجمالا يمكن القول، إن الجائزة ليست تشريفًا للفرد بقدر ما هي تكليف له بأداء دوره كمثقف عضوي فاعل وفعال ومساهم في تقدم مجتمعه.
٢ هل يمكن القول إن الجائزة تحفز المبدعين الأمازيغ على مزيد من العطاء في كل المجالات؟
بكل تأكيد فجائزة الثقافة الأمازيغية هي تشجيع مادي ومعنوي للباحثين والمبدعين الأمازيغ على بذل المزيد من الجهود في مجال البحث العلمي الرصين، غير أن هذا الأخير يعاني من صعوبات وإكراهات، خاصة في مجال الدراسات التاريخية، وتحديدا البحث في فترة الحمايتين الفرنسية والإسبانية بالمغرب، لأن هذه الفترة لا تزال مرحلة غامضة في تاريخنا، رغم جهود الباحثين حولها.، فالإنتاج التاريخي المغربي في مرحلة الاستقلال من الناحية الزمنية، ظل لمدة طويلة سجين مرحلة ما قبل الحماية، ولم تلق الفترة التي ينعتها المؤرخون المغاربة بالتاريخ المعاصر القريب أو تاريخ الزمن الراهن، فترة الحماية وما بعدها، الاهتمام نفسه لعوامل مفسرة كثيرة، منها ما يرتبط بالوثائق المتفرقة بين الخزانات العمومية أو الخاصة داخل المغرب وخارجه، أو ربائد الأرشيف الكولونيالي الموجودة في مراكز أرشيفية أجنبية يصعب على الباحث عنها وفيها وُلوجها أو الوصول إليها، أو إلى بعضها أو كلها، لأسباب مادية أو سياسية، يخبِّر بها من تاهت به سبل البحث عنها، أو ما يغلب على كتابات مرحلة الاستقلال السياسي بالمغرب، خاصة جنس السير الذاتية أو الغيرية، من تضاربات واتهامات وأنانيات وذاتيات، تجعل الباحث الموضوعي في حيرة من أمره، وعلى مسافة بعيدة من الخلاصات المتحررة من مختلف النزعات الاستعمارية أو الوطنية، كما تعيق طموح تحقيق التراكم الضروري لقراءة وكتابة تاريخ الحماية كتابة موضوعية علمية متحررة من القراءات الإيديولوجية، ولتهيئ الشروط الذاتية والموضوعية لكتابة تاريخ وطني تركيبي واسع يرتكز على التاريخين المحلي والجهوي، ويتجاوز الدور الضيق الذي أصبحت تلعبه بعض الجامعات المغربية في التنشيط الثقافي المحلي أو الجهوي، فيما أن العمل الذي ينبغي أن تقوم به الجامعة المغربية، في رأيي، هو تشجيع الباحثين والباحثات، خاصة في شعب العلوم الاجتماعية والإنسانية على توسيع البحث في فترة الحماية والتاريخ الراهن بالمغرب، بتسهيل الولوج إلى الوثائق عبر منح تشجيعية، كما هو الشأن لدي جيراننا في تونس والجزائر، أو وضعها رهن إشارة الباحثين دون الحاجة إلى تحمل مشاق التنقل والإقامة في المراكز الأرشيفية الأجنبية.
وبالعودة إلى الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية في مجال الأبحاث والدراسات لهذه السنة 2024م، فلقد خصصت جائزة واحدة لهذا الصنف مثلها مثل صنف المسرح مثلا، وعلى عكس بعض الأصناف الأخرى مثل الأدب والأغنية العصرية والرقص الجماعي والسينما، التي خصصت لها أكثر من جائزة واحدة. أعتقد أن مجالي الأبحاث والدراسات والمسرح الأمازيغي، يستحقان أكثر من جائزة واحدة لكل صنف، بالنظر للعدد الكبير من المشاريع التي ترشحت للجائزة. ولقد انتبهت لجنة الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية لذلك في تقريرها الافتتاحي إلى ذلك عندما أوصت بتوسيع دائرة المبدعين والمبدعات الأمازيغ الذين سيتوجون بهذه الجائزة الهامة بالمغرب في القادم من الدورات. كما ينبغي تتبع الأعمال الفائزة بالترويج والتعريف وفتح آفاق واسعة ورحبة للباحثين والباحثات والمبدعين والمبدعات الأمازيغ، في تظاهرات وطنية وجهوية ومحلية.
أعتقد كذلك أن تقييد جوائز الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية بشرط عدم ترشح الفائزين بالجائزة إلا بعد انقضاء أجل خمس سنوات، فيه ضياع للجهود، خاصة في صفوف الشباب في مجالات الإبداع الأدبي بالأمازيغية وحول الأمازيغية، ومن تم ينبغي تشجيع هؤلاء بخلق جوائز جديدة تواكب تحول الخطاب حول الجهة والجهوية المتقدمة.
٣ من خلال تجربتك هل فعلا الأمازيغية استطاعت أن تجد لها مكانا في مجالات الإبداع الأدبي والعلوم الاجتماعية وتنافس باقي اللغات أم ما يزال حضورها في مجال الكتابة والابداع محتشما؟
حضور الأمازيغية في مجالات الإبداع الأدبي والعلوم الاجتماعية بالمغرب هو أمر لا يمكن نفيه بل حاضر بقوة في الزمن الراهن، خاصة بعد فترة الانفراج والانفتاح السياسيين تجاهها، منذ العام 2001 تاريخ تأسيس المعهد بموجب الظهير الشريف الصادر في 17 أكتوبر 2001، والذي يعتبر تأسيسه منعطفا مفصليا لسياسة جديدة تجاه الثقافة الأمازيغية، بما في ذلك إطلاق جائزة تهدف إلى النهوض وحماية وتطوير الثقافة الأمازيغية في مختلف تجلياتها، عبر تشجيع مبدعيها وفنانيها ومفكريها وباحثيها، والتي انطلقت تحديدا منذ العام 2004، لتعزز بإدراجها لغة وثقافة في المنظومة التربوبة المغربية منذ 2003 ، وفي دستور المملكة المغربية منذ 2011م.
إن حضور الأمازيغية هو أمر مستجد في الحياة العامة بالمغرب، غير أنه في تطور مطرد، ولعل عدد المشاريع التي تقدمت للجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية لسنة 2024، أو التي تقدمت لوزارة الشباب والثقافة والتواصل في إطار دعم نشر الكتاب بالأمازيغية وحول الأمازيغية برسم سنة 2025، يعكس تطوراً ملحوظاً وتزايدا في الإسهامات في مختلف المجالات والأصناف الخاصة بالإبداع الأدبي الأمازيغي، والدراسات والأبحاث، والتطبيقات والموارد الرقمية، والإعلام والاتصال، والمخطوط، والترجمة، والأغنيتين العصرية والتقليدية، والرقص الجماعي، والفيلم والمسرح الأمازيغيين.
إلا أن الأمازيغية لم تصل بعد إلى مستوى منافسة اللغات المهيمنة عالمياً. لأن طريق الوصول إلى العالمية لازال طويلا جدا وسيكون شاقا بكل تأكيد، مما يكرس هيمنة لغات عالمية في الساحة الدولية وازدياد الفجوة المعرفية بين الشمال والجنوب، وذلك بفعل تحديات تواجه الإبداع الأمازيغي ، في مقدمتها الحاجة إلى مزيد من الدعم ، حيث يتطلب الحضور الدولي للمبدعين الأمازيغ، خاصة في مجال التكنولوجيا والمسرح والسينما الترجمة والنشر والتطوير الأكاديمي ، مزيدًا من الدعم ، إن لم نقل تمييزا إيجابيا تجاه الأمازيغية والأمازيغ لتدارك التخلف الكبير الذي يعرفه الإبداع الأمازيغي في مختلف المجالات، بحيث لا يمكن أن نتصور استمرار المخرجين الأمازيغ في تمويل مشاريعهم السينمائية الباهظة الثمن من جيوبهم على حساب مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، في ظل استمرار غياب صندوق خاص لدعم الأعمال السينمائية الأمازيغية، واعتبار السينما الأمازيغية إبداع زائد أو مواز للإبداعات السينمائية الأخرى.
كما تعاني الأمازيغية من غياب منصات نشر عالمية كافية، وترجمة أعمالها الأدبية والعلمية على نطاق واسع، وهو ما يحد من وصولها إلى العالمية.
ولتحسين حضور الأمازيغية في مجالات الإبداع الأدبي والعلوم الاجتماعية بالمغرب وخارجه ، ينبغي تعزيز الجهود الموجهة إلى الترجمة والنشر على نطاق عالمي، وتوفير منصات دولية للمبدعين الأمازيغ، وإقامة فعاليات دولية لتبادل الأفكار والمعارف والتعريف بها وترويجها. كما ينبغي إخراج الأمازيغية من الوضع المعرقل لها على مستوى جميع مجالات الحياة العامة من تعليم، وإعلام، وثقافة، وإدارة، وسياسة، ونشاط اقتصادي، وذلك من خلال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ودمجها في مختلف الهياكل والمؤسسات الحكومية.
للأسف هناك هوة سحيقة تفصل بين القول والفعل في مجال تفعيل الفصل الخامس من دستور المملكة لسنة 2011، وتحديدا في مجال تفعيل مواد القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية. فالفاحص لالتزامات الدولة المغربية في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وعلاقتها بالواقع الفعلي في مجال الممارسة، يدرك أن مكان الأمازيغية في مجالات الإبداع الأدبي والعلوم الاجتماعية بالمغرب في خطر، وأن حضورها في مجال الكتابة والابداع بالمغرب مهدد بالزول، رغم الإرادات الحديدية لمبدعيها في المقاومة والاستمرار.
حاورته نادية بودرة
 جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر


